ركّزنا في مقالينا السابقين على دور القطاع التعاوني في التنمية، انطلاقا من فرضيتين أساسيتين: الأولى، أن التعاون يُعتبر في علم الاقتصاد من الآليات الفعّالة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية في البلد، في ظل شح الموارد المالية وثقل الدين الخارجي وفشل سياسة اقتصاد السوق الحر وما سببته في دفع بلادنا إلى الهاوية. والفرضية الثانية، أن التعاون يحقق تبني سياسة اقتصادية قومية، يشارك في وضعها المواطنون، تسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في مجالي الإنتاج والخدمات، عبر المراقبة والمساءلة والشفافية والمشاركة المباشرة في عملية إنتاج وتوزيع الموارد والدخل القومي، وتصحيح أداء السوق المحلي. وقلنا إن القطاع التعاوني، بهذا الفهم، يمثّل عاملا أساسيا في التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان. وفي المقالين، ضربنا مثلا لذلك بمساهمتين، الأولى عن دور التعاون في تنمية منطقة النوبة، وصلتنا من الأستاذ كمال إبراهيم أحمد، والثانية عن سياسة اقتصاد الطاقة، وصلتنا من الدكتور شمس الدين خيّال، وهي كانت جزءا من ورقة بحثية عن القطاع التعاوني، نلخّص في مقال اليوم جزأها الثاني والمتعلق بأهمية أن تتبنى الحكومة الانتقالية قيام قطاع مصرفي تعاوني لتمويل النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي.
يبتدر الدكتور شمس الدين حديثه بالتأكيد على أن نظام الإنقاذ لم يراع الأبجديات الاقتصادية الضرورية لنجاح العمل المصرفي، حتى ينهض بدوره الاقتصادي في مد الوحدات الانتاجية والخدمية برأس المال المطلوب. وأن توجه حكام الإنقاذ كان الدفع بالنظام المصرفي لتمويل خلصاء النظام من الإسلاميين، حتى يتمكنوا اقتصاديا، وبالتالي سياسيا. وتبعا لذلك، ترسخ في عهد الإنقاذ نظام بنكي تطغي فيه سياسة الربح القصوى، وتمويل أنشطة المضاربة في الأراضي والعقارات والسيارات والعمل التجاري ذو الربح العالي والسريع. وأن استغلال الإنقاذ للنظام البنكي كأداة سياسية، تجسّد في استخدام ودائع العملاء في نشر سياسة تمويلية بعيدة كل البعد عن المقاييس والضوابط البنكية المتعارف عليها. كذلك أدى استغلال النظام البنكي كأداة للتمكين الاقتصادي والسياسي، الى تمويل البنوك التجارية عن طريق البنك المركزي دون الالتزام بالقواعد الضمانية المالية المعمول بها في كل الأنظمة المالية في العالم. وتبعا لذلك، تمددت الكتلة المالية المتداولة وتضاعف حجمها حتى وصل درجة أكبر بكثير من الأداء والحوجة الاقتصادية القومية، مما زاد من ارتفاع التضخم المالي، وتسارع وتيرة فقدان الجنيه السوداني لقوته الشرائية. واليوم، وبعد عام من تشكيل حكومة الثورة الانتقالية، يعاني الاقتصاد السوداني من آثار نظام مصرفي ومالي منهار، فقد ثقة عملائه، ودفع بالقدر الأكبر من كتلة النقود المتداولة للتواجد خارجه، حتى وصلت نسبة التضخم، في يوليو/تموز 2020، إلى 143,78 في المئة.
وللخروج من هذا الوضع المتأزم، يقترح الدكتور شمس الدين خيّال الإسراع بتأسيس نظام مصرفي تعاوني، حتى يرتكز النظام المصرفي في السودان على ثلاثة أعمدة، هي القطاع المصرفي التعاوني، والقطاع المصرفي التجاري الخاص، والقطاع المصرفي التجاري الحكومي، أو العام. وحجّة الدكتور شمس الدين في تحمّسه للقطاع المصرفي التعاوني، تستند على التجارب الناجحة والملموسة في العديد من بلدان العالم، كما تستند على القيمة والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، والتي تتمثل في مجموعة من السمات التي اختبرت في الواقع العملي، والتي هي أيضا بمثابة منبع للثقة الشعبية تجاه المصرف التعاوني. ومن أهم هذه السمات:
النظام المصرفي التعاوني يتأسس على مبدأ التعاون من اجل العون والإدارة والمسؤولية الذاتية.
وسياسته غير موجهة نحو الربحية القصوى كما هو الأمر في طبيعة النظام المصرفي التجاري.
المشاركون يمثلون كل شرائح المجتمع، والبنك التعاوني يكون دائما متاحا لغير الاعضاء كعملاء، العضو المشارك يحمل صفة المالك، ويساهم في رسم وتحديد وتطوير سياسة البنك، تمويل النشاط الحرفي والمنتج والخدمي من الحجم الصغير الي المتوسط، بناء قطاع استثماري جماهيري حديث، وتمويل ادخال التكنولوجية الحديثة في الانتاج.
تنمية الريف ورفع المقدرات العلمية والفنية للمزارعين، وتدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم، مما يقلل من النزوح السكاني من الأقاليم، ادخال ثقافة المشاركة الاستثمارية الخاصة.
استدامة التمويل حتى في مراحل الأزمات المالية حيث أن القطاع التعاوني يعتمد بقدر كبير على مشاركة الأعضاء المالية ومدخراتهم، وغير مجبر على الاستدانة من السوق العالمي.
لصفته الاجتماعية، يمكن لقطاع المصارف التعاوني أن يلعب دورا مهما في دعم النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.
وإضافة إلى مجالات العمل المعروفة، كالزراعة والتربية الحيوانية والصناعة والتعدين وتمويل النشاط الحرفي والخدمي كالتجارة والتأمين الصحي..الخ، يمكن قيام بنوك تعاونية فئوية تؤسسها اتحادات ونقابات العاملين، كذلك يمكن تحفيز سودانيي المهجر لإنشاء بنك تعاوني لتقديم رأس المال للاستثمار في مشاريع ذات عائد مادي لأعضائها وعملائها. وفي ألمانيا مثلا، يُعتبر البنك التعاوني للأطباء والصيدلة والعاملين في المجال الصحي حسب ميزانيته البالغة 50 مليار يورو، أكبر مصرف تعاوني في المانيا، حيث تبلغ عضويته 115.884، وعدد عملائه و481.000، ويعمل به 2.488 موظف في 85 فرعا له.
ولضمان ضبط الأداء المالي للبنوك التعاونية، يقترح دكتور خيّال قيام «بنك اتحاد البنوك التعاونية» ليتولى دور البنك التعاوني المركزي في المراقبة وحلقة الوصل مع البنك المركزي في البلد ومع البنوك الأجنبية، ومع «اتحاد البنوك الشعبية العالمي» في بروكسل، مما يعزز الثقة في هذا القطاع. كما يقترح تنظيم ورش عمل، سمنارات، مؤتمرات…الخ، تضم خبراء في مجال الاقتصاد والإدارة والقانون والتعاون وممثلين للمجتمع المدني من كل اقاليم السودان والجهات الرسمية المسؤولة عن قطاع التعاون، من اجل الخروج بتوصيات للمؤتمر القومي الدستوري بهدف تثبيت القطاع التعاوني دستوريا كعمود ثالث في الاقتصاد السوداني، بجانب القطاعين الخاص والعام، وكأداة سياسة اقتصادية فعّالة تحد من تركيز الثروة القومية في أيدي أقلية، أو في ولايات محددة دون غيرها.
المقالات
الشفيع خضر يكتب : القطاع المصرفي في السودان
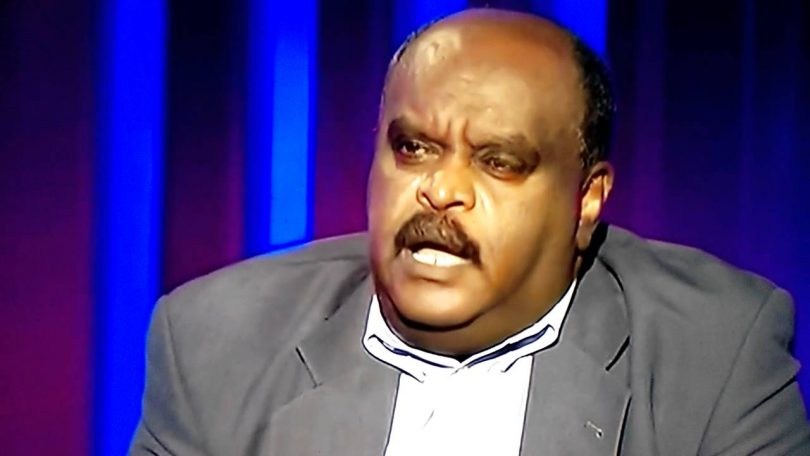
التعليقات